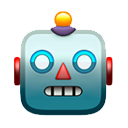The rejection of all religious and moral principles, in the belief that life is meaningless.
ترجمة :
الرفض التام لجميع المبادئ الدينية والأخلاقية، والإعتقاد بأن الحياة لا معنى لها.
en.oxforddictionaries.com/definition/nih…
بمعنى آخر : لا معنى من دون الصراع ولا صراع من دون التناقض ولو كان جزئياً.
وكذلك العدم والوجود، فالعدم هو الوجه الآخر للوجود وبه نعرف حقيقة الحياة.
فكتب يقول "دعونا نضع ثقتنا في الروح الأبدية التي تدمر وتبيد فقط لأنها مصدر الإبداع لكل الحياة، الشغف بالتدمير هو أيضا شغف إبداعي".
ويعدّ الأديب والشاعر والروائي الألماني جوتفريد بن من أبرز العدميين الذين وضحوا معنى العدمية كمذهب أدبي.
وبالنسبة إلى ستيرنر، فإن تحقيق الحرية الفرديّة هو القانون الوحيد، والدولة التي تضر بالحرية الفردية ضرورةً يجب تدميرها.
وبحلول نهاية القرن العشرين، فسح اليأس الوجودي المجال أم اللامبالاة كاستجابة للعدمية، والتي ارتبطت بالنزعة الأنتي-تأسيسية (النزعة التأسيسية المضادة).
دعت الحركة إلى إقامة ترتيب اجتماعي قائم على النزعتين: العقلانية والمادية كمصدر وحيد وأساسي للمعرفة، والحرية الفردية كأسمى هدف في الوجود.
وفي نهاية سبعينات القرن الثامن عشر أصبح العدمي هو أي شخص متورط أو مرتبط مع الحركات السياسية السرية.
تطور المفهوم بمرور الوقت على يد العدميين من أمثال فريدريش جاكوبي وزمرة الروائيين من أمثال ايفان تورجنيف وغيره.
فلسفتي تنحصر في إنعدام الغائية "الكونية"، وغياب المعنى "الجوهري" للحياة وليس المعنى الواقعي.
النموذج الذي قمت بتطويره عن نموذج جان بول سارتر هو أن الجوهر قد يتحلل ويموت "موت المعنى" بالرغم من عدم تحلل الوجود الواقعي "الحياة".
رؤية العالم كله بنظارات وردية "إيجابية" سذاجة لأنه يتضمن إنكاراً لحقيقة واقعية وهي الشر.
الشخص العدمي يمسك العصا من الوسط ويرى العالم بمنطقية الوقائع، وحكمة التاريخ، وبأمانة المنهج العلمي.
العدمي لا ينفرد برؤية كونية أحادية قطبية عن الخير أو الشر، فهو يرى "الخير" و "الشر" في نفس الوقت.
لأن النظريات العلمية بما تحتويه من تفسيرات منطقية دقيقة ومتماسكة تغني عن "الإله" تماماً.
ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين يرى تصارُع إراداتهم مع إرادته بوضوح ومنطقية.
العدمية المعاصرة تستدعي مبدأ "تجاوز القيم السائدة" transvaluation يتجاوز كل الحلول والإفتراضات الدينية.
بحسب النموذج الذي أتبناه "العدميّة الوجودية" فالجواب : ليس فعلاً، لأن معظم الأشياء القيّمة وذات المعنى العميق "ليس جوهرياً بالضرورة" مؤقتة.
لذلك قد يوجد المعنى "الواقعي" وهو الضروري للحياة نتيجة التكيف، بالرغم من إفتقاد المعنى "الجوهري" للحياة.